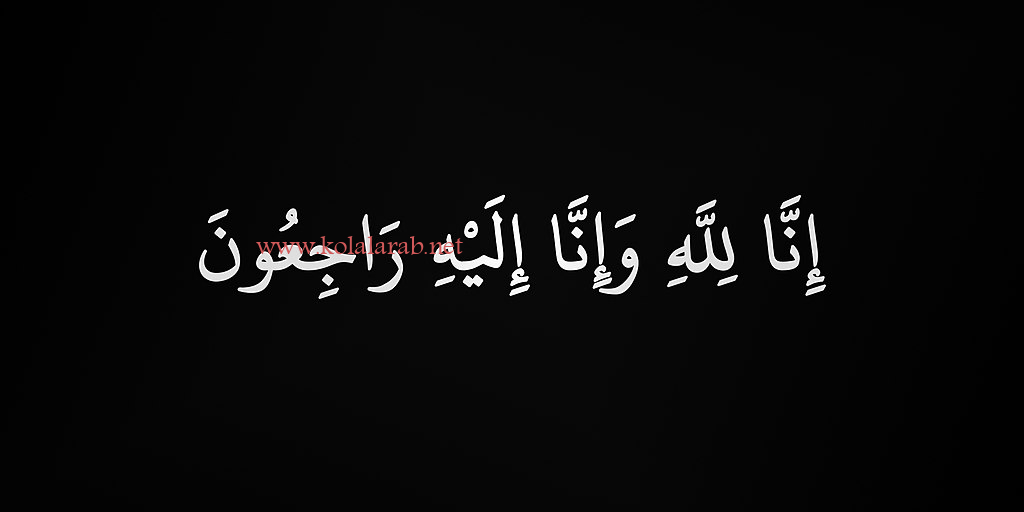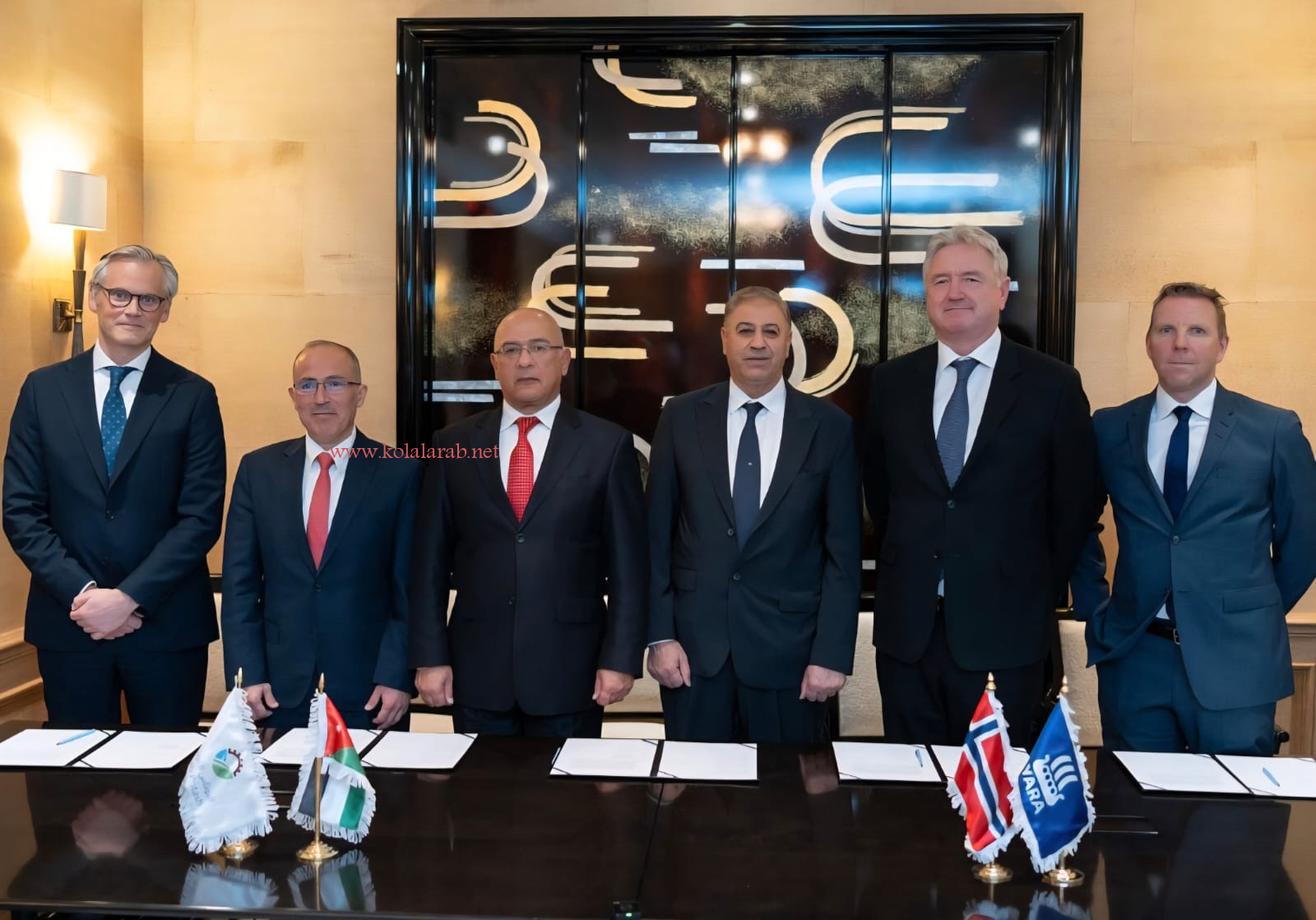|
نطلاق أعمال المؤتمر الفكري الموسّع "مستقبل الثقافة العربية الإسلامية الوسطية" في ابوظبي
 وكالة كل العرب الاخبارية : انطلقت، صباح اليوم، أعمال المؤتمر الفكري الموسّع عن "مستقبل الثقافة العربية الإسلامية الوسطية" في مقر المركز في أبوظبي، بحضور نخبة من المفكرين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وباحثين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بلدان عربية وأجنبية لمناقشة 14 ورقة بحثية في أربع جلسات على مدى يومين. وقال الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" في افتتاح المؤتمر ان المنطقة العربية شهدت في السنوات الأخيرة، ولا تزال، تحولات سياسية فارقة لا تخفى علينا جميعاً، كان من أبرز نتائجها أن أصبحت تيارات وجماعات دينية في صدارة الفاعلين السياسيين في دول عدّة". وقال : ومن البديهي أن يكون لمثل هذه التحولات آثار ونتائج نوعية تستحق الدراسة والبحث العميقَين، ولاسيما بعد أن بات ديننا الإسلامي الحنيف موضع أخذ وردّ وجدل سياسي متصاعد، وبعد أن زُجَّ به في أتون صراعات ستفرز من دون شك عواقب سلبية، ليس على مستوى استقرار المجتمعات العربية في اللحظة التاريخية الراهنة فقط، بل قد تمتد لتطول الصورة النمطية التي سادت واستقرت لقرون مضت حول وسطية الإسلام وسماته الفريدة في التسامح وقبول الآخر. وأكد أن متابعة هذا الفيض الهائل من التداخل، على مستوى الممارسات والسلوكيات اليومية لبعض التيارات والجماعات الإسلامية، بين الدين والسياسة، تُظهر ما يفرزه من تشويه ممنهج لصحيح ديننا الإسلامي الحنيف، من خلال تبنّي شعارات ودعوات ومواقف إعلامية ظاهرها الدفاع عن شرع الله وباطنها وهدفها السياسة والبحث عن المكانة والسلطة والنفوذ، والاستقواء في ذلك برؤى دينية حصرية تتخذ من الميل الفطري للشعوب العربية نحو التدين سبيلاً لتحقيق رغباتها، لتكريس أهدافها. ويضعنا ذلك في مواجهة تناقض صارخ بين الإسلام الصحيح الذي يدعونا إلى الوسطية في قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً"، والعمل السياسي بكل ما يحيط به من خروقات والتباسات. وكانت النتيجة أن تفرغ كثير من الشعوب العربية لمتابعة ما يجري من صراعات بين الدين والسياسة، وهي صراعات تتمحور في الأساس حول هوية أوطان لم يُعرف عنها يوماً سوى كونها دولاً إسلامية حتى النخاع، بل إن الأمر تجاوز الصراع بين تيارات إسلامية ومنافسيها إلى صراعات ربما تكون أشدّ وأقوى بين هذه التيارات الإسلامية نفسها. وأشار السويدي إلى أنه في ظل هذا الصراع العبثي يتم تشويه الدين، وتغيب خطوات التنشئة السياسية السليمة، ونغرق جميعاً فيما يسمى إعادة قراءة الماضي، وتضيع من بين أيدينا خريطة الواقع الراهن المملوء بالتحديات والمعوقات التنموية، ويدفع ملايين البسطاء من الشعوب العربية فاتورة باهظة ربما يستغرق الوفاء بها عشرات السنين. وأكد أن الثقافة الإسلامية الوسطية تعيش أزمة حقيقية وسط هذا الطوفان من التشدد والتطرف الأيديولوجي، وليس هناك من مخرج أو بديل سوى دعم هذه الثقافة ومساندتها، ليس لكي تتجاوز أمتنا العربية والإسلامية هذا الظرف التاريخي الصعب فقط، ولكن أيضاً لكي نحافظ على أجيالنا من تغلغل فكر التشدد والتطرف إلى الأفئدة والعقول، سواء عبر المنابر الدعوية والمنافذ الإعلامية، أو من خلال مناهج تعليمية تسعى هذه الجماعات إلى تغييرها في بعض الدول العربية بما يتوافق مع أهوائها وفكرها، قائلاً: لذا فإننا نرى أن أمتنا العربية في مأزق تاريخي، تحاول بعض التيارات والجماعات اختزاله وتبريره وتفسيره في سياق ديني تاريخي، بما يجعلنا في غياب دائم عن واقعنا، ويدفعنا إلى الاستغراق في الجدلين الفكري والفقهي في وقت نبدو فيه أحوج ما نكون إلى رؤى وطروحات مستنيرة وأفكار متجددة بدلاً من هدر الوقت في مناقشة قضايا حسمها الشرع منذ قرون، والاستبسال دفاعاً عن خطاب ديني منغلق يعطّل طاقات الشباب، ويسد منافذ الأمل، ويضع مصير أمتنا العربية في مهب ريح عاتية. وقال السويدي: إن دولنا العربية تواجه تحديات ومشكلات عديدة في وقت تحتاج فيه إلى بلورة صيغ تنموية متوازنة بين التطور الحضاري المادي من جهة، والبناء الروحي من جهة ثانية، والحفاظ على هويتها الثقافية من جهة ثالثة. والأمر المؤكد أن التمسك بالوسطية الإسلامية يُعدُّ المخرج الوحيد لتطبيق وتلاقي صيغ كهذه، فلا إفراط ولا تفريط، ولا تطرف ولا عنف في الدين، مع إطلاق طاقات العمل والإبداع والتفكير وتحصين المجتمعات ضد الغلو والتطرف؛ فمعبر أمتنا العربية الإسلامية إلى الخلاص من واقعها المتردّي هو فهم ديننا الإسلامي الحنيف فهماً صحيحاً، فالإسلام منذ فجره أرسى مبادئ مجتمعية غاية في الأهمية أبرزها التعددية وحرية الاعتقاد، مكرِّساً وسطية لا ترى مثلها أبداً، فوسطية إسلامنا الحنيف -كما قال بها العلماء- هي حق بين باطلين، واعتدال بين تطرفين، وعدل بين ظلمين. وخاطب السويدي الحضور الكريم قائلاً: نحن نثق كل الثقة بمنعة الثقافة الإسلامية الوسطية وحصانتها، ومقدرتها على نبذ التشدد والتطرف ومواجهة أيّ محاولة لاختطاف الدين الإسلامي وادعاء امتلاك وكالات حصرية له، سواء على مستوى التفسير، أو على مستوى الدعوة والتدبير، ونستمد قدراً كبيراً من ثقتنا هذه من وجود مؤسسات دينية عريقة تصون الثقافة الإسلامية الوسطية، وتدافع عنها، وتحفظ للإسلام بوصلته وهويته الحقيقية، وتقوم على نشرها في مختلف أرجاء العالم، وفي صدارة هذه المؤسسات الأزهر الشريف أكبر مؤسسة دينية في العالمين العربي والإسلامي، بما يمثله من عراقة فكرية وعلمية وبما نلمسه جميعاً من اجتهاد فقهي يميز علماءه الأجلاء، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يواجه حملات شعواء تتستر برداء الدين، وتلتحف بمصالح الدنيا، مستهدفة في الأساس رمزية فضيلته لوسطية لا تزال تقف حجر عثرة في طريق الانغلاق والتشدد. وأضاف السويدي في كلمته: إننا ندرك أيضاً أن السبيل الوحيد للحفاظ على مصالح شعوبنا ودولنا العربية ينطلق من المقدرة على بناء نموذج لإسلام وسطيّ قائم على التعايش السلمي وقبول الآخر، ونبذ التعصب والرغبة في التسلط والهيمنة، سواء على السلطة أو على بقية شركاء الوطن، وبالقدر نفسه نؤمن بأن حضارة الإسلام الحنيف ترتبط في جوهرها بقيم هذا الدين ومبادئه السمحة ووسطيته التي ظلت لعقود بمنزلة صمام الأمان للحفاظ على أمن المجتمعات العربية والإسلامية واستقرارها، مشيراً سعادته إلى أننا لا نسعى في مؤتمرنا هذا إلى نقد ممارسات نثق برفض المجتمعات الإسلامية لها، بقدر ما نسعى إلى توفير قوة دفع للجهود الرامية إلى استنهاض أمتنا العربية على أسس وركائز نابعة من فكر إسلامي قويم، والتعريف بالإسلام الحقيقي لا كما يُقدَّم من جانب بعض الجماعات ديناً منغلقاً متعصباً رافضاً للآخر. كما نسعى أيضاً إلى استجلاء حقائق الأمور وفق نسق فكري وسطي بعيداً عن الاستعلاء في النص والحوار.
بعدها ألقى فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبوالنور، وزير الأوقاف الأسبق في جمهورية مصر العربية، الكلمة الرئيسية للمؤتمر نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، وأكد فيها الدور الإنساني والإسلامي الثقافي الوسطي الذي تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يرسخ ثقافة الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر، والانفتاح على المجتمعات الإنسانية دون إقصاء لأحد باعتبار أن الجميع إخوة وشركاء في الإنسانية، متسائلاً كيف نريد من العالم والمجتمعات الأخرى أن تتحدث إلينا وتحاورنا، ونحن لا نتحدث إليها ولا نحاورها، ونقصيها؟ وقال إن الأزهر يثمّن النهج الذي اختطته دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء المؤسسات الإسلامية المنتشرة في جميع أرجاء الدولة، ورعايتها لأكثر من 70 هيئة وجهة مختصة في الدراسات الإسلامية، ومراكز البحوث والدراسات المتخصصة والمنتديات والجوائز في هذا المجال، التي تتوخى جميعها الهدف السامي بنشر الثقافة الإسلامية الوسطية البعيدة عن الغلو والتطرف، بل بات هذا النهج شاهداً حقيقياً اليوم على الوسطية والاعتدال والتوازن في الثقافة العربية والإسلامية الوسطية من أجل تكوين جيل ليس على الصعيد المحلي فقط، بل على المستوى الدولي، لنبذ التعصب ونشر التسامح واحترام الرأي الآخر. وقال فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبوالنور: لقد جاءت هذه الدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة في وقتها تماماً، للكشف عن جوهر الثقافة الإسلامية الوسطية التي تبني ولا تهدم. الوسطية هي خاصية الإسلام ومقتضاه، والإسلام والأمة الإسلامية هما الدين والأمة الوسط، والشواهد على ذلك من المصحف الشريف والسنة النبوية المطهرة كثيرة، مشيراً إلى أن الحوار بالتي هي أحسن يعد من باب أولى في حال الحوار مع القريب. وفي السنة النبوية قصص معتبرة حول جواز مخاطبة الكافر الموجود عندك في دارك بـ"الأخ". من هنا ينبغي أن تكون لنا بالناس جميعاً أخوة إما دينية وإما إنسانية، فأسلوبك مع الناس له تأثير كبير في الدعوة إلى الله تعالى. هذه رسالتنا، وعلينا اتباعها داخلياً وخارجياً. وبدأت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "نظرة تحليلية في تيارات الفكر الإسلامي العامة" التي رأسها الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدها قدّم الدكتور عمار علي حسن، الباحث والمفكِّر المصري، ورقة بحثية عن التيار السلفي، أكد فيها أن السلفية ليست تنظيماً محكماً من الممكن تطويقه، إنما أفكار طارت بلا أجنحة عبر التاريخ، سواء اتفقنا أو اختلفنا معها. ويحاول كثير من الأنظمة اجتذاب ما تسمى "السلفية المستأنسة" في مواجهة تيارات ناصبت هذه الأنظمة العداء، ونازعتها على الحكم، مشيراً إلى أن السلفية تعود إلى المعركة الفكرية التي دارت في القرن الثالث الهجري بين المعتزلة والأشاعرة الذين قدّروا العقل على اختلاف في الدرجة، وأهل الحديث الذين قالوا إن العقل لا يحل محل النص، واتهموا خصومهم بأنهم خرجوا من الإبداع إلى الابتداع. وتبدأ سلسلة الفكر السلفي مع ابن حنبل، وأبي جعفر الطحاوي، وصولاً إلى ابن تيمية الذي قاوم ما سماه خيانة ملوك الطوائف، وانتهاءً إلى محمد بن عبدالوهاب في القرن الثامن عشر. وأشار إلى أن السلفية نزعة دينية محافظة يشكل الله مركزها، ولا يشكل الإنسان مركزاً لها. وهي فلسفة سياسية انقيادية بحكم طاعتها لولي الأمر، وترى أن الأمور تتجه دائماً إلى الأسوأ، كلما ابتعدنا زمنياً عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهي تعود دائماً إلى الوراء للبحث عن الحلول. وتدّعي السلفية أنها الوريث الشرعي للنبوة وطريق السلف الصالح، وتمثل نقاء الإسلام وصفاءه الأول. وتنكر السلفية التعددية، وترى أن الدين دين واحد، والصواب طريق واحدة. ولا تقتصر الرؤية المعرفية للسلفية على من نسميهم السلفيين، إذ تسربت إلى الجماعات الإسلامية الأخرى، فهناك حديث عن "تسلف الإخوان المسلمين"، وغيرهم من الجماعات الدينية. وبيّن أن السلفية تحمل مشروعاً سياسياً مستتراً ومشروعاً جهادياً، حتى لو ادَّعت غير ذلك كما تفعل، وهي تنتظر نضج الظروف لإبراز مشروعها في لحظة معينة، في وقت تعرضت السلفية فيه لنقد من تيارات فكرية متعددة، ومنها تيارات إسلامية شتى. وتبرز في هذا المجال رؤية المفكر الإسلامي جمال البنا، الذي يقول إننا يجب أن نفارق السلفية إذا أردنا أن نتقدم في الحياة. وعرفت السلفية انشقاقات كثيرة حول المصالح والمنافع، أو حول تفسير النص. وتظهر الخلافات أكثر كلما سعت الجماعات السلفية إلى السياسة أو السلطة، مشيراً إلى أن السلفية تنقسم إلى أقسام مختلفة، وفقاً لزوايا النظر، فمنها السلفية القديمة التي يمثلها ابن حنبل وابن تيمية. وسلفية حديثة يمثلها محمد بن عبدالوهاب. وهناك السلفية العلمية التي تقتصر على البحث والنظر الشرعي. والسلفية الحركية التي تهدف إلى نشر أفكارها بين المسلمين. وهناك السلفية الجهادية التي تتوزع بين السلفية الجهادية في كل دولة على حدة، والسلفية الجهادية الدولية التي تطرح نفسها على مستوى العالم كله مثل تنظيم "القاعدة". وهناك كذلك سلفية محافظة تعيد إنتاج الفكرة والتجربة التاريخية (مثل الوهابية والألبانية)، وتهدف إلى تغيير المجتمع عبر مراحل أربع هي: التصفية، والتربية، والمفاصلة، والجهاد. والسلفية الإصلاحية التي يضم إليها بعض الباحثين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبدالرحمن الكواكبي، وهي سلفية تنظر إلى القديم لكنها لا تخاصم الجديد. وحول زاوية التماسك، قال إن هناك سلفية سائلة، وسلفية منتظمة. فالسلفية السائلة أفراد لا يجمعهم ناظم أو جماعة، بل يتبعون أفكار شيخ عبر الفضائيات أو الحلقات الدراسية دون رابط تنظيمي، فضلاً عن أن هناك السلفية الموالية أو المستأنَسة التي تغالي في تحريم الخروج على ولي الأمر، كالجامية أو المدخلية في المملكة العربية السعودية، وهناك سلفية معارضة تمثلها السرورية في المملكة العربية السعودية أيضاً، كما أن هناك عناصر أربعة يتعين الاهتمام بها، وتركيز الحوار الإسلامي حولها، على النحو التالي: - مدى إمكانية الوصول إلى حد فاصل بين النص والتاريخ. - مدى إمكانية الوصول إلى حد فاصل بين النص والخطاب. - مدى إمكانية الوصول إلى حد فاصل بين المبادئ والقيم العامة والتجسيد الاجتماعي لها، فليس أحد حجة على الدين، ولا عصمة لعلوم الدين، وهناك فرق بين الدين والتدين الذي يتخذ أشكالاً بشرية تخطئ وتصيب. - مدى إمكانية الوصول إلى حد فاصل بين مكانة الرموز التاريخية، حتى لو كانوا من الصحابة، وقدسية المبادئ التي أقرها الإسلام، فالوقائع التاريخية تثبت أن السياسة كانت الخنجر المسموم الذي طعن الأديان، ومنها الإسلام. وخلص إلى القول "إننا لن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام مادمنا نبحث عن حل مشكلاتنا الجديدة في كتبنا القديمة". بعدها تحدث الدكتور خالد عبداللطيف، المدرس في جامعة المدينة العالمية، الباحث في وزارة الأوقاف المصرية، عن التيار الصوفي في الإسلام، وأشار في ورقته البحثية إلى أن الثقافة الإسلامية عرِفت بوفرة روافدها، ومنها الفكر الصوفي وما امتاز به من عمق، وقال إن التصوف الإسلامي لا يخرج عن الغاية التي خلق لأجلها الإنسان، وهي تحقيق العبودية لله تعالى، إذ كل التعريفات التي عرّفت التصوف اهتمت بصفاء الظاهر والباطن، ورد النفس إلى العبودية الخالصة لله. ويتلخص ذلك كله في عبارة "التقوى": التقوى لله وللعباد؛ وهذا ما نزل به الوحي، وتدور عليه مقاصد الشريعة. وبيّن أن التصوف كعلم وعمل مورس في العهد النبوي، فهو من المنبع الصافي المضارع لمقام الإحسان الذي وصف في الحديث النبوي الشريف "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك". كما أن سبب عدم انتشار الدعوة إلى التصوف في عهد صدر الإسلام، هو ببساطة عدم الحاجة إلى تحديده بالعبارة والمنهج المستقل؛ فلقد كان حضور النبي صلى الله عليه وسلم مَعيناً نهل منه الجميع بشكل مباشر، وتربوا عليه التربية الروحية الظاهرة والباطنية الشاملة التامة. وأضاف: فلما تقادم العهد، وانتشرت رقعة الدولة، وكثرت العلوم والترجمات، وبدأ عصر التدوين لشتى العلوم المتفرعة من القرآن والسنة، وأخذ التأثير الروحي يتضاءل، شرع أرباب الرياضة والتصوف في التأليف في مجال الرقائق والزهد، وإن لم يكن ذلك تحت "علم التصوف"، سداً للقصور وحرصاً على تربية النفس، مشيراً إلى بيان التصوف الإسلامي بأنه مجاهدة ورياضة محكومة بالفقه الشرعي والسنة النبوية، تصل بالصوفي إلى مقام اليقين؛ وقد شرح الإمام أبوحامد الغزالي ذلك في كتابه "إحياء علوم الدين"، وخاصة في تركيزه على قطع عقبات النفس وتربيتها وتحليها بالسمو بالأخلاق. فالأخلاق هي العماد والسند، وبذلك يمكن أن تكون بديلاً للتصوف في هذا المقام. لقد عرف التصوف السني المعتدل بدوره في النشر السلمي للإسلام في أفريقيا وآسيا، ودوره في حرب المستعمر: البرتغالي والإسباني والفرنسي، ومن تلك الطرق الصوفية: السنوسية والقادرية والشاذلية، في وقت تعرض التصوف فيه، كغيره من سائر الظواهر الاجتماعية، لكثير من المراحل المعرفية، كمرحلة النقد والتنقية من شتى المظاهر الجانبية، لكن السماحة والاعتدال والتماس العذر والإخلاص لله تعالى، تظل كلها سمات التصوف السني المعتدل، الموجّه للإنسان نحو "الإحسان" الذي هو أسمى مقاصد العبودية لرب العالمين. ثم أعقبه الدكتور حسن حنفي، المفكر والأستاذ الجامعي في كلية الآداب في جامعة القاهرة؛ ليتحدث عن التيارين العلماني والإسلامي الوسطي، وأشار إلى أن ورقته تهدف إلى تحليل التيارين العلماني والإسلامي الوسطي تحليلاً علمياً "فربما نستطيع عن طريق العلم أن نجد أسساً مشتركة وأهدافاً واحدة لهما". وقال: إن العلماني يتصور الإسلام مجموعة من العقائد تغلب عليها الغيبيات، ومجموعة من الشعائر والعبادات تغلب عليها الأشكال والرموز، ومجموعة من الأحكام يغلب عليها المحرمات لا المباحات. والإسلامي يتصور العلماني غربي الاتجاه ينكر العقائد والشرائع. والذي يفكر في هذين التصورين يجد أنهما خاطئان، فليست العلمانية كما يتصورها الإسلامي، وليست الإسلامية كما يتصورها العلماني، فالإسلام به مصالح الدنيا، والشريعة الإسلامية تقوم على المقاصد الخمسة المعروفة، الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فهل يختلف ذلك عما يردده العلماني على لسان روسو ومونتيسكو؟ إن الشريعة الإسلامية شريعة وضعية، وأحكامها وضعية، أي أنها تقوم في هذا العالم وتستند إليه. في علوم القرآن، كما وصفها أهلها، يتحدثون عن أسباب النزول، فماذا تعني أسباب النزول؟ هذا ما لا يعرفه العلماني: أن لكل حكم شرعي سبباً وواقعة، لذلك نجد في القرآن الكريم كثيراً من الآيات تبدأ بـ"ويسألونك عن"، ويأتي في جوابها "قل". الحكم الشرعي ردٌّ على سؤال نشأ في الواقع. أليس هذا هو ما يقوله العلماني من أن القوانين وضعية تبدأ من واقع اجتماعي وسياسي؟ وأضاف أن العلمانية تقول إنها أيديولوجيا تقوم على العقل. أليس العقل مقصداً من مقاصد الشريعة؟ أليس حفظ العرض هو ما يسمونه حقوق الإنسان؟ لو حللنا الألفاظ المعتدلة في كل تيار لوجدنا أنه لا فرق بين العلمانية بهذا المعنى والإسلام بهذا المعنى، فأين المصلحة في قرع الاتجاهين بعضهما ببعض؟ لا مجال لصواب مطلق لفكرة وخطأ الأفكار الأخرى. إن حديث الفرقة الناجية يشكك فيه ابن حزم وابن تيمية، فهذا ليس من روح الإسلام. لا أريد أن يقال إنني أوفق بين تيارين كما أوصف باستمرار، أو أؤسس لعلمانية إسلامية، أو إسلامية علمانية، بل أحاول تحليل تاريخنا تحليلاً علمياً موضوعياً لا سياسياً. والتحدي الذي نواجهه نحن -المثقفين العرب- هو وضع مفاهيم جديدة، لأن الحق يجمع بين الأطراف ولا يفرق.
تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|