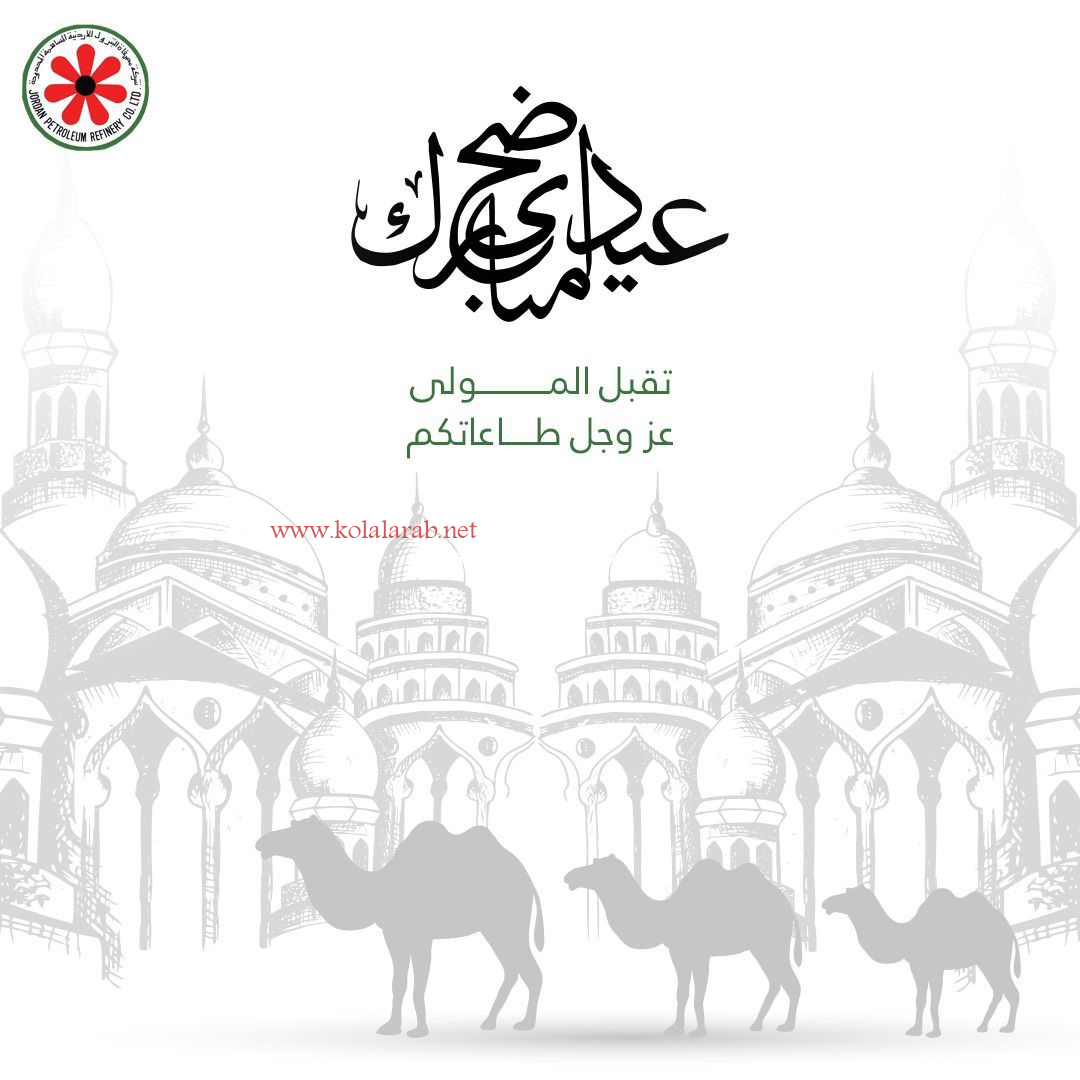وكالة كل العرب الاخبارية : في مجتمعات الدنيا، تتراوح المشكلات والنزاعات مراتب عدة، منها ما تقف السلطة الثالثة (القضائية) عاجزة عن حله؛ لما يشوب تلك المشكلات من ظروف ودوافع ونزاعات، ما يرتب حالة من الخوف على الأمن الوطني في البلدان.
في بلد كالأردن، تعتبر العشائر ركيزته الأولى، بقيت الاحكام العشائرية، ومنذ تأسيسه، تقف كـ"حجر الرحى"، لاستمرار حياة الناس فيه، وحتى بعد التطورات التي صاحبت تطور الدولة، حافظت العشائر على عادة "القضوة العشائرية"، إلى جانب القضاء المدني.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في "المادة 10" منه على أن "لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه له"، هذا البند لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع القضاء العشائري، وفقاً للعين الشيخ طلال الصيتان الماضي، حيث أن الأخير داعم وسند لتقارب العشائر وتآلفها، كما أنه لا يلغي الأول بل يعززه.
ويرى الماضي ان القضاء العشائري له مساهمة كبيرة في حل القضايا والاشكالات، عازيا ذلك إلى أن القانون المدني "يتعامل" مع الجاني والمجني عليه؛ أما القانون العشائري فيتعامل مع ما يسمى "خمسة الدم"، أي "أقرب خمسة أجداد للشخص، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان" لمرتكب الخطأ، وبهذا يكون الحل معنوياً أكثر منه مادياً.
ويعتبر أن القضاء العشائري "مقنع" للأطراف الأخرى، لمخاطبته "خمسة الدم" للمجني عليه، بحيث تحمل "خمسة الدم" للجاني المسؤولية الأخلاقية على الأقل، ما لم تكن المسؤولية مادية.
وبهذا تساهم العشائرية، حسب العين الماضي، في "استقرار المجتمع، لأنه عندما يتعرض شخص للاعتداء، فلا شك أن الأمر سيكون مزعجا لأقاربه، وأيضا فإن أقارب الشخص المعتدي يجب أن يتحملوا جزءا من المسؤولية الأخلاقية".
"خمسة الدم" وحقوق الإنسان
على أن "خمسة الدم" تلقى معارضة واسعة في المجتمع الأردني، خاصة في قضية "الجلوة العشائرية" التي تعني، ترحيل أهالي من يرتكب الجريمة إلى خارج منطقتهم، وهو ما يثير حفيظة منظمات دولية، تستند في موقفها إلى المادتين "12 و13" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وتنص المادة "12" على أن "لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته (...) ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات"، فيما تقول المادة "13" في بندها الأول أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود الدولة"، وفي البند الثاني ينص على أنه "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه".
وتقع الجلوة في العرف العشائري على كل فرد في منظومة الجاني، ويرتبط معه بصلة قربى تمتد حتى الجد الخامس، وقد توصل العرب إلى هذا من نظرية التماسك واللحمة الواحدة، المتمثلة بأصابع اليد الواحدة، حيث أن الخمسة أصابع في اليد الواحدة تشترك مجتمعة في قبضة السيف، أو ما بحكمه، والذي عادة ما يكون سببا في القتل.
ويلفت العين الماضي إلى أن العشائرية بطبيعة تكوينها المجتمعية "عبارة عن كيان اجتماعي موحد، توحده الجغرافيا والدم، حيث كانت العشائر في وقت من الأوقات، قبل وجود الدولة الأردنية وفي بدايات التأسيس، تحكم نفسها من خلال عادات وتقاليد مجتمع معين، إذ أن أي كيان مجتمعي أو أي مجتمع لابد له من ضوابط تحكمه".
الانتقال من الحكم العشائري إلى المدني
ويجد الماضي أن عملية الانتقال من الحكم العشائري إلى القانون المدني مرت بتجارب، كان فيها نوع من الصعوبة "حيث كان لابد للمشرع في الدولة من إيجاد مواءمة ما بين القضائين العشائري والمدني، لأن القانون المدني في نهاية الأمر هو قانون وضعي، والوضعي يعتمد على العادات والتقاليد وطبيعة الشخص".
ويتابع "أنا أعتقد أن ثقافة الشخص مهمة جدا في التشريع؛ فنحن نستقي كثيرا من تشريعاتنا من القوانين الفرنسية والبريطانية وحتى المصرية، فكثير من هذه القوانين تختلف ثقافة شعوبها مع ثقافة الشعب الأردني، فكان لابد من أن يكون هناك تباين بينها؛ فأحيانا غير مريح اللجوء إلى القضاء المدني في بعض القضايا".
لكن العين الماضي لم يغفل الإشارة إلى أن النظام السياسي في الأردن "على درجة كبيرة من الوعي والذكاء"، وبالتالي "كان لابد من أن يبقي بعض القضايا المهمة جدا، لكي تحكم من خلال القانون الإداري؛ وهو قانون الحكام الإداريين، وتم الاتفاق على تلك القضايا؛ وهي ثلاث: قضايا العرض والقتل وتقطيع الوجه، وماعدا ذلك من قضايا يبت فيها القضاء المدني".
ويقول "سارت تلك الأمور بهذه الطريقة، وكان القضاء العشائري له الكلمة الفصل في كثير من القضايا، التي كانت تنتهي عشائريا، ومن ثم يتم إنهاء الإجراءات المتبقية في القضاء المدني".
"الجلوة" تقلب حياة أسر رأسا على عقب
في الكرك؛ تعاني عائلة أبو طلال من الجلوة العشائرية، التي حولت حياتها، بحسبه، إلى "جحيم"؛ ففي أحد الأيام قدمت مركبات شحن تابعة للأمن العام، وتحت إشراف الحاكم الإداري، وقامت بنقل العشرات من الأسر القريبة لشخص قتل آخر إلى مكان آخر، حرصا على حياتهم مما يسمى "فورة الدم"، لتطبق عليهم الجلوة العشائرية.
وما تزال عائلة أبو طلال، ومعها أسر أخرى، تعاني من ابتعادها عن منازلها، حيث تتجمع عشرات الأسر في عدة منازل في بلدة أخرى، وقد تغيرت حياتها كلها، بدءا من مكان العمل ودراسة الأبناء والعلاقات الاجتماعية ومتطلبات الحياة العادية، في الوقت الذي أهملت فيه مصالح تلك العائلات في منطقة سكناها، وأصبحت بيوتها خرابا وكذلك ممتلكاتها من المزارع والبساتين.
ويعيش حاليا في محافظة الكرك المئات من الاشخاص حياة الجلوة العشائرية، التي فرضت على عائلات سبعة أفراد من العشائر في المحافظة بسبب ارتكاب بعض أفرادها جرائم قتل، وفي الوقت نفسه أصبحت مئات المنازل خالية من أهلها ورحل اصحابها عنها، وأحيانا إلى خارج المحافظة.
ذات الأمر ينطبق على عائلة في السلط، دين ابنها بقتل رجل مسن في إحدى القرى، وعندما ثبت التورط، حكم بالجلوة والدية، وبحسب الحكم العشائري أجليت العائلة حتى الجد الثالث، لأن أقاربه من الجد الرابع والخامس يقطنون في محافظة أخرى.
ثلاثية الدستور والقانون والقضاء العشائري
تنص المادة التاسعة من الفصل الثاني من الدستور الأردني، المتعلق بـ"حقوق الأردنيين وواجباتهم"، على أنه "لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين، إلا في الأحوال المبينة في القانون"، وهذا ما يتعارض تماما مع "الجلوة" التي يتعامل معها القضاء العشائري.
ويعلق رئيس محكمة مادبا الشرعية القاضي الدكتور جمال التميمي على الموضوع، بالتأكيد على أن القضاء العشائري يساهم مساهمة كبيرة في حل كثير من المشكلات الاجتماعية، ويساعد القضاء الشرعي والمدني في التخفيف من عدد القضايا المرفوعة في المحاكم، وهو نقطة مضيئة في الثقافة والتراث الأردني".
ويلفت التميمي إلى أن الاحتكام للقضاء العشائري بدأ منذ أواخر عهد الدولة العثمانية، بشكل مباشر، لحين قيام الدولة، مؤكدا أن القضاء العشائري كان الفيصل في أغلب المنازعات الفردية والجماعية بين الأفراد والقبائل، وأنه كان رديفا للقانون المدني وساعد الدولة في حل كثير من الإشكالات، التي استعصت وما تزال تستعصي على القوانين المدنية.
ويضيف "رغم أن القضاء العشائري لم يكن موثقا، وكان يعتمد على المشافهة، إلا أنه حظي بالاحترام والتقدير، وعليه يمكن حل كثير من المشكلات قبل وصولها للقضاء بشقيه الشرعي والنظامي".وحول ما يثار من أن القضاء العشائري سبب مشكلات مجتمعية، يرى التميمي أن من "يقول بأن القضاء العشائري والعرف العشائري، بخصوص موضوع الجاهة والعطوة وتقطيع الوجه والحق، زاد المشاكل في المجتمع، فقوله ليس دقيقا، لأن القضاء والعرف العشائري يشكل رادعا، وخط دفاع أول عن المجتمع، على ألا يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الواجب مراعاتها والاحتكام إليها، فموضوع ضبط الأخذ بالثأر والإصلاح بين الناس لا تحكمه قوانين، بل عادات وتقاليد، التي لها دور في ردم الهوة بين المتخاصمين".
وحول دور القضاء المدني عقب قيام نظيره العشائري بحل مشكلة ما، يشير التميمي، إلى عدم وجود تقاطع بين عمل القضاء النظامي والعشائري في حالات كثيرة. ويوضح أن القاضي في المحاكم ينظر في القضية المرفوعة أمامه، و"لا يجبر الناس على الخصومة إلا إذا تعلق الأمر بالحق العام، فللنائب العام تحريك القضية، وعليه فلا تقاطع بينهما".
ويضيف أن القضاء العشائري "يبحث في أغلب المشكلات، ولا توجد قضايا لا يبحثها القضاء العشائري؛ فهو يبحث جرائم القتل والعرض والإيذاء المعنوي والمادي، وهذه الجرائم ليست هي الجرائم الوحيدة التي يعاقب عليها القضاء العشائري، ولكنها تعتبر من أهمها".
"تطييب" الخواطر في القضاء العشائري
إلى ذلك، يرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة "البترا" الدكتور اسماعيل الزيود أن الدولة الأردنية حتى اللحظة "تقدم القضاء العشائري على المدني؛ لأن فيه نوعا من أخذ الخواطر وتطييبها". ويعتبر أن القضاء العشائري "معزز وليس هاضما للحقوق، فالإجراءات تسير في المحكمة، والوجهاء يسيرون في القضاء العشائري لحفظ التآلف بالمجتمع".
ويتابع أن الأردني يلجأ للقضاء العشائري أحيانا "إذا شعر بأن القضاء المدني لن يجلب له حقه وفيه ضعف، بالإضافة إلى أن البعض يعتبرون العشائري مطبق لقاعدة العين بالعين والسن بالسن؛ المطبقة منذ عهد الملك حامورابي"، وهي قاعدة دينية ليست موجودة بالقضاء المدني.
ويؤكد الزيود أن "مجتمعنا لا يمكن عزله عن المجتمع العربي فروح القبيلة ما تزال فيه"، مستشهدا على ذلك بعدة أشياء كالانتخابات النيابية والبلدية وغيرها. ويلفت في الوقت نفسه، إلى أن بعض الأمور تحتاج لـ"تطوير وتغيير للأفضل كالجلوة العشائرية التي تتسبب بصعوبات ومشكلات للعائلات التي تتعرض لها".
على أن الزيود يشير إلى حل متمثل بما يسمى في علم الاجتماع بـ"قوة الضغط"، المتمثلة بالعشيرة والنقابات والأحزاب، على أن تحفظ الجانب الإيجابي للقضاء العشائري، المتمثل بردع الوقوع في الجرائم والمشكلات المختلفة.
بدوره، يؤكد الناشط الحقوقي والمحامي محمد بني هاني أن "لا تعارض" بين القضاءين العشائري والمدني، إلا في "الجلوة العشائرية" و"حقوق ذوي المجني عليه"، حيث أنهما يتعارضان مع حقوق الإنسان المرعية دوليا، فالأول فيه حظر على حياة الناس ومنع لأبسط حقوقهم، وليس على شخص وإنما على عائلة بأكملها.
ويزيد بني هاني أن "حقوق ذوي المجني عليه "في قضايا القتل يتم هضمها في بعض الأحيان في القضاء العشائري، من قبل الجاني وذويه"، مبينا أن المحاكمة واحدة سواء استخدم القضاء العشائري أم لم يستخدم، ولكن "يجب أن تعدل بعض الأحكام في القضاء العشائري، ليكون غير متعارض مع حياة الناس وحقهم في الحياة الطبيعية، وتحميلهم وزر غيرهم".
* أعدّ لبرنامج الاعلام وحقوق الانسان مركز حماية وحرية الصحفيين